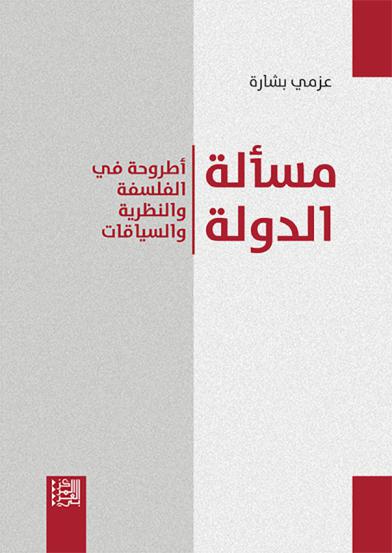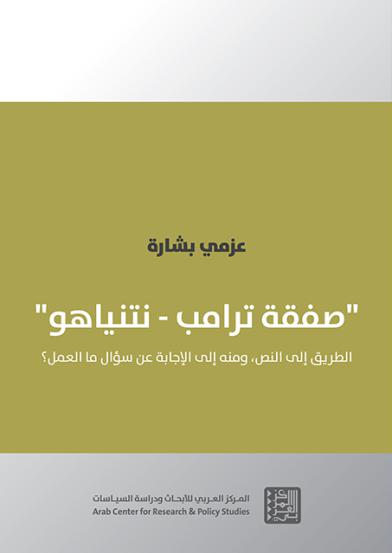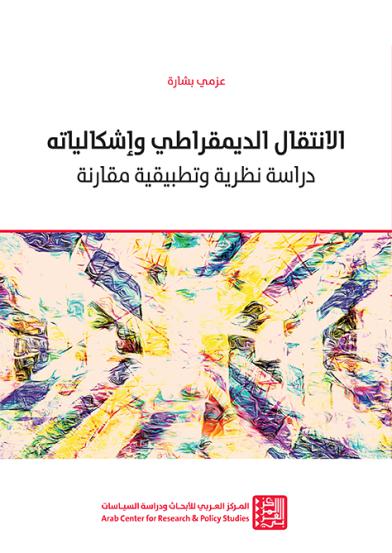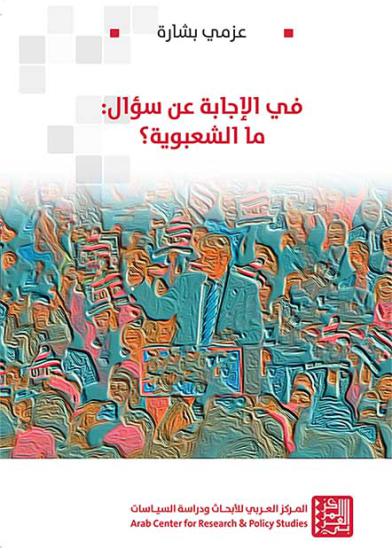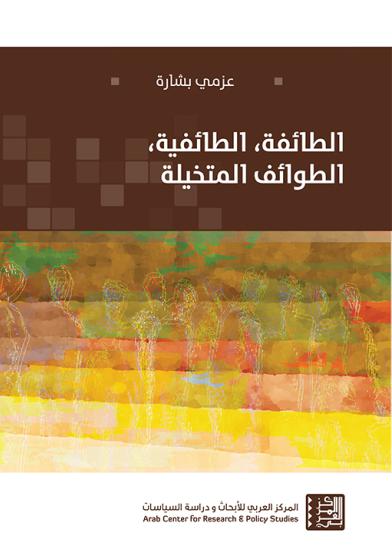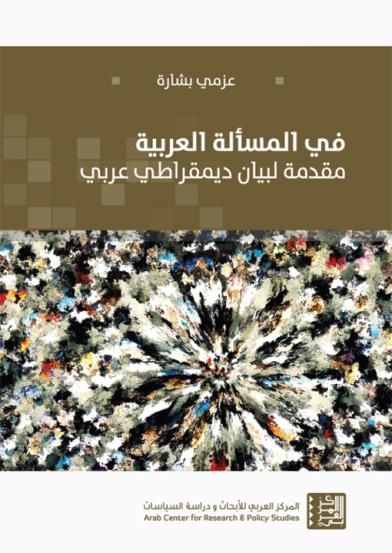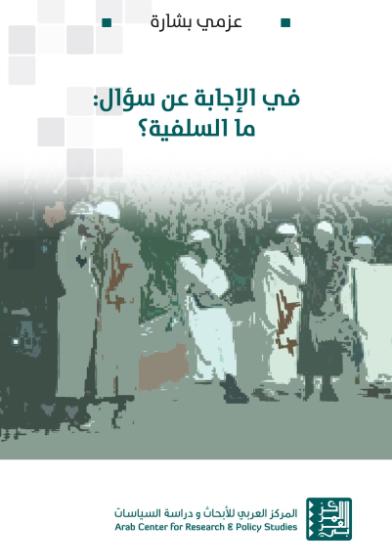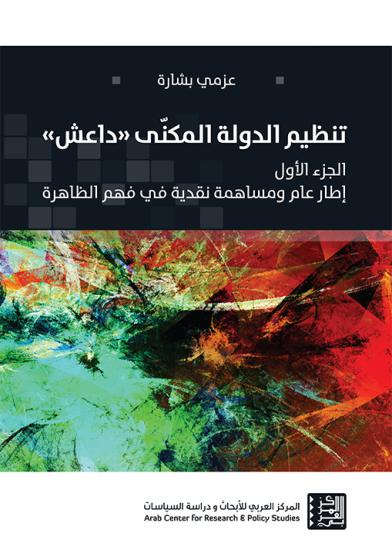سياح أم رهائن؟
صحيفة المدن
محمد العزير
ربيع العام 1981 حاصرت القوات السورية مدينة زحلة عاصمة البقاع اللبناني، وحاولت اقتحامها للحد من النفوذ المتنامي لقائد "القوات اللبنانية" في حينه بشير الجميل، في منطقة يعتبرها النظام السوري داخل مجاله الحيوي. إنشغلت حكومات الغرب في حيته، وبحماسة فرنسية غير مسبوقة، بتلك المواجهة ولم يهدأ الرئيس الإشتراكي الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران قبل أن يضمن خروجاً غير مهين لمقاتلي القوات اللبنانية الذين جعلوا من تلك المواجهة انتصاراً ناجزاً مهد الطريق امام الجميل الى رئاسة الجمهورية بعد أقل من سنتين.
لم تكن معركة زحلة أول أو أكبر معركة تخوضها القوات السورية في لبنان، لكن الهوية الدينية للمدينة أعطت الإهتمام الغربي، وليس الفرنسي وحده، نوعاً من الشرعية التلقائية، "الغرب المسيحي" يدافع عن عاصمة الكثلكة في الشرق. سيتكرر هذا السيناريو بتعديلات طفيفة عندما لجأ الجنرال ميشال عون الى السفارة الفرنسية بعد فراره من قصر بعبدا. يومها قال الرئيس الفرنسي نفسه، والذي يعرف جيداً حروب لبنان أن شرف فرنسا يأبى المس بلاجئ السفارة.
ربيع العام 2003 تجتاح القوات الأميركية العراق. الدمار يغطي أرض الرافدين عشرات آلاف القتلى والجرحى والمشردين. يتدخل الفاتيكان علناً ويقوم بحملة دبلوماسية عالمية لإنقاذ حياة طارق عزيز، أشهر مسؤول عراقي بعد صدام حسين، والسبب أنه مسيحي. بعد ذلك يدخل العراق في أتون الفوضى والإختراب ولكن الخبر الأساس، بعدما تعود العالم على عادية الموت في العراق، صار إعتداء على كنيسة أو على ابناء الأقليات المسيحية في العراق.
حتى في الربيع العربي، وعلى الرغم من التعاطف الغربي معه في مراحله الرومانسية الأولى، حافظت الحكومات ووسائل الإعلام الغربية على تظهير الخصوصية الفصوى لسلامة المسيحيين واماكن عبادتهم من تونس الى ليبيا ثم الى مصر، وصارت اخبار ويوميات المواجهات والإعتداءات توازي أخبار أكبر زلزال عربي إن لم تسبقها الى الصفحات الأولى ومقدمات نشرات الأخبار.
ثم جاءت الثورة الشعبية السورية بتفاصيلها المريعة لتعطي هذا المنحى بعداً اكثر نفوراً. نظام مدجج بالحقد والسلاح والدموية يرتكب بحق المدنيين، ما كان كثيرون يعتقدون انه لم يعد ممكناً أو جائزاً في القرن الحادي والعشرين، ويحظى بدعم لا لبس فيه من الكنائس المشرقية وامتداداتها الكاثوليكية، بموازاة دعم دول وقوى لطالما اعتبرتها الحكومات الغربية مارقة وخارجة على القانون الدولي، أو إرهابية، ولكن فوق جثث عشرات الآف القتلى والجرحى وفوق عذابات ملايين اللاجئين والمشردين وفوق كل هذا الدمار الهائل، الخبر الأبرز في صحف الغرب، والهم الأبرز لمسؤولي الغرب، وصلوات ودعاءات رجال الدين في الغرب، هو اختطاف كاهن هنا، او اقتحام كنيسة هناك والطامة الكبرى التي لا توازيها داهية الإقتراب الى معلولا أو الإشتباك في وادي النصارى.
بكيفية ما، نجحت النخب الغربية بعد مرحلة الإستقلال التي اعقبت الإنتداب والحرب العالمية الثانية، في تصوير المسيحيين العرب وكأنهم مجموعة سياح انقطعت بهم السبل في غابة بعيدة. استعاضت هذه النخب التي تحاضر في حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والتسامح والديموقراطية عن هم الشعب العربي ككل بهم اقلية منه فقط، وكأنها تغسل يديها من ارث استعماري غير مشرف، بتحويل "الهم المسيحي" الى قضية ذات ملامح انسانية ومضمون ملتبس. ووجدت الحكومات الغربية في ذلك مخرجاً شبه لائق خصوصاً في مرحلة الحرب الباردة التي كانت نبراس السياسة الخارجية الغربية، لكن تجاهل تلك النخب والحكومات لمسيحيي فلسطين كأقلية جديرة بالإهتمام، التزاماً بالأولوية الإسرائيلية، كرست تهافت المنطق الغربي وزادت من معاناة الكيل بمكيالين.
لم يكن الإستثمار الأقلوي الغربي امتداداً طبيعياً لسياسة الأقليات التي عممتها أوروبا في المشرق العربي اواخر أيام الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر. كان مفهوم الأقليات في حينه شاملاً ولم تكن قاعدته دينية تماماً. كانت قوى أوروبا الناهضة بفعل تراكم مؤثرات الثورة الصناعية تبحث عن موطئ قدم على ارض "الرجل المريض". لم يكن الدين شرطاً. فاذا حصل ان تجد فرنسا اقلية كاثوليكية لا يعني ان بريطانيا لن تتعامل مع غير البروتستانت، وكانت الولاءات تتبدل دون كبير وزن للمضمون الديني.
وجاء الصعود الكبير لليمين الديني الأميركي مع بدء تفكك الإتحاد السوفياتي وزوال "الخطر الشيوعي" في مرحلة رئاسة رونالد ريغان، لينقل هذه المقاربة الى مستوى أعلى تمثل في اقرار الكونغرس قانون مراقبة الحريات الدينية في العالم عام 1998 والذي يعني عملياً توفير مظلة قانونية فاعلة لدعاوى الإضطهاد الديني وانشاء لجنة حكومية مهمتها متابعة شؤون الأقليات الدينية في العالم، أي تلقائياً العالم الإسلامي، وربما الصين عندما تدعو الحاجة.
تحويل هذه المسألة الى ثابتة في السياسة الخارجية الغربية لم يكن وليد هذه المقاربة فقط. التقط الضباط العرب الذين شقوا طريقهم بالدبابات الى مركز القرار هذه الإشارات مبكراً، وكان من السهل عليهم في غياب مفهوم المواطنة تحويل الأقليات المسيحية حصراً الى ما يشبه "رعايا" يستفيدون من حماية الحاكم الشخصية لهم كـ"أقلية"، ليصبح ذلك مادة دائمة على جدول اعمال أية قمة عربية مع دولة غربية. وصار هذا الإستثمار لاحقاً مغرياً لأنظمة لا تحتاج اليه أصلاً، لذلك ليس غريباً ما كشفته الثورة المصرية من تورط لمخابرات نظام حسني مبارك في افتعال المواجهات الطائفية وخصوصاً في الصعيد المصري.
وساهم القمع الشامل في المجتمعات العربية وتماهي الكنيسة مع السلطة في رفد هذه المقاربة بطرف محلي آخر من المسيحيين أنفسهم. ففي ظل التشجيع الرسمي الغربي لهجرة المسيحيين دفعت الظروف المعيشية الكثيرين منهم للجوء الى أوروبا وأميركا الشمالية بحثاً عن حياة أفضل، ووجد بعض الطامحين من دينيين ومدنيين في ذلك فرصة للإستثمار السياسي مستظلين المؤسسات التبشيرية وغلاة المتطرفين للترويج للمظلومية الدينية وتوفير مادة دائمة لرفد السياسة الرسمية المعلنة. بالطبع لم تكن الدوائر المؤيدة لإسرائيل بأذرعتها الإعلامية والسياسية بعيدة عن الصورة لإبقائها دوماً كقضية رأي عام.
ولم يقصر "أعداء" أميركا والغرب من تلاوين الإسلام "الجهادي" في إستغلال ذلك الى أبعد مدى، وأكتشف قادتهم الخارجين من احشاء الأنظمة البوليسية والمتدربين على أيدي المخابرات الغربية نفسها، التي احتاجتهم سابقاً، في مواجهة الشيوعية والحالات الوطنية، أن أقصر طريق لتقديم اوراق اعتمادهم كـ"إرهاب" معترف به هو التصويب على مواطنيهم المسيحيين، كما حصل في مصر والعراق وأخيراً في سوريا.
من النتائج المباشرة لـ"الربيع العربي" أنه كشف هذا الجانب الملتبس من السياسة الحكومية الغربية التي تتعامل مع المسألة كترف قابل لغض النظر، تماماً مثلما كانت دعاوى الديموقراطية وحقوق الإنسان، الأميركية خصوصاً، تتهاوى أمام المصالح. الفارق هنا أن تحويل المسيحيين العرب الى مشاريع "رهائن وضحايا" تم بتعاون النخب المعنية في ظل انسداد أفق السياسة وطنياً وانعدام مفهوم المواطنة وتغييب المجتمع عن صنع القرار إن لم يكن عرضة للتهييج الطائفي المبرمج من السلطة. والأمل لا زال معقوداً على "الربيع العربي" المضرج بالدم حتى الآن في قلب هذه المعادلة لإستبدالها بالمواطنة وسيادة القانون.
كتب
عُرِف عزمي بشارة بإنتاجه الفكري الغزير وأبحاثه المرجعية في مجالات المجتمع المدني، ونظريات القومية وما أسماه "المسألة العربية"، والدّين والعلمانية