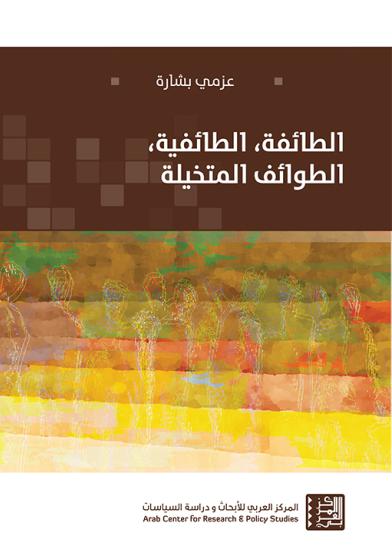أبعاد العنف الطائفي في الساحل السوري
تقييم حالة
وحدة الدراسات السورية المعاصرة
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
مقدمة
غدت القضية الطائفية هاجسًا مؤرقًا لكثيرٍ من السوريين، وبخاصة بعد تحوّل الثورة من الطابع السلمي إلى العمل المسلح تحت ضغط العنف المفرط الذي استخدمه النظام السوري ضد المدنيين السوريين وتجاهل المجتمع الدولي معاناتهم. وعلى الرغم من ظهور حالات متفرقة من العنف الطائفي خلال المرحلة السلميّة[1]، فإنّ وتيرته قد ارتفعت حدتها مع تحوّل الثورة باتجاه العمل العسكري. ومع ذلك، ظلّ الساحل السوري بمنأى عن الاقتتال الطائفي حتى صيف 2013.
تهدف هذه الورقة إلى تقصّي بدايات ظهور العنف الطائفي في الساحل السوري، وتتبع الأسباب التي أدت إلى انتقال المنطقة من حالة الاستقطاب الطائفي إلى مجازر ذهب ضحيتها مئات المدنيين. وتحذِّر الورقة من إمكانية أن تشهد المنطقة حالات تغيير ديموغرافي أو حتى تطهير طائفي في حال تفاقمت المواجهات على هذا الأساس.
من الاستقطاب الطائفي إلى المجازر
انفجرت المشكلة الطائفية في سورية مع تطور الصراع، وكان النظام السوري هو المحرِّض الأساسي على ذلك من خلال اتهامه الثورة منذ أسبوعها الأول بالفتنة الطائفية، وأخذ إعلامه الرسمي وغير الرسمي يبثّ خطابًا طائفيًا في محاولةٍ حثيثةٍ لدفع المحتجين للرد بصورة طائفية. كما ارتفعت وتائر المشكلة الطائفية مع إفراط النظام وميليشياته باستخدام القوة، وإضفاء طابع طائفي مقصود على عنفه في محطات عديدة، دفع الشعب السوري خلالها آلاف الضحايا في تظاهرات سلمية بشكل عام، مما دفع الأهالي مع مطلع عام 2012 إلى حمل السلاح كإستراتيجية جديدة لتحقيق مطالب الثورة. وقد ردّ النظام على ذلك بقصف المدن والأحياء التي توجد فيها المعارضة المسلحة واستخدم مختلف أنواع الأسلحة.
لقد بدأت مظاهر العنف الطائفي بصورة متكررة وسط احتقانٍ ملموسٍ في مدينة حمص في المنطقة الوسطى من سورية مع مطلع عام 2012، ومن ثمّ انتقلت إلى ريف حماة في منتصف العام ذاته، حتى وصلت في عام 2013 بشكل متقطع وتدريجي إلى ريف دمشق مثل منطقتي "الذيابية" و"جديدة الفضل"، وكذلك في بعض المناطق في شمال سورية وشرقها.
وإذا ما فصلنا مسألة العنف السياسي عن العنف الطائفي والعنف الاجتماعي الأهلي، فيمكننا القول إنّ الساحل السوري انتقل من مرحلة الاستقطاب الطائفي إلى حالة من جرائم ومجازر كبرى ذهب ضحيتها مئات المدنيين، فضلًا عن حالات العنف الطائفي الفردية؛ أي تلك التي يرتكبها أفراد منفلتون من عقالهم كما كان يحدث في حمص وريف حماة. بدأ العنف الطائفي الواضح المعالم في الساحل السوري في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس بقيام اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني من القرى العلوية المجاورة باستباحة "قرية البيضا" في ريف بانياس وحي النبع داخل المدينة في 2-4 أيار/ مايو 2013[2]، حيث يسكنهما أهالي من السُنة. جاءت هذه الأعمال بعد كمين مسلح تعرضت له دورية من الجيش السوري، تبعتها مداهمات لقرية البيضا[3]، واقتحام كلا المنطقتين. خلّفت المجزرة[4] التي ارتكبتها بطرق بشعة الميليشيات الطائفية[5] بقيادة علي الكيالي الذي يتزعم ميليشيا "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"[6]، عددًا كبيرًا من القتلى من الأطفال والنساء. وعلى إثر ذلك، هجر الكثير من العائلات بانياس إلى مدينتي جبلة واللاذقية خوفًا من مصير مشابه للعائلات المنكوبة.
بعد نحو ثلاثة أشهر على مجزرة بانياس، أي في 4 آب/ أغسطس 2013، بدأت قوات مسلحة في ريف اللاذقية - تحسب نفسها على المعارضة - هجومًا على قرى صغيرة في ريف اللاذقية يقطنها علويون[7]. شارك في الهجوم كتائب جهادية وأخرى تنضوي تحت يافطة "الجيش الحر"، أبرزها "أحرار الشام" ومجموعة من المتطرفين الإسلاميين خاصة في كتيبة "المهاجرون" ومعظمهم من الليبيين[8]. وبعد أن استطاعت تلك القوات السيطرة على بعض هذه القرى، قامت بقتل العشرات من الأشخاص[9]، وخطفت ما يزيد على 100 طفل وامرأة من بينهم رجل دين يدعى بدر الدين غزال[10]، لا يزال مصيرهم مجهولًا. كما فرَّ بقية أهالي تلك القرى إلى مدينة اللاذقية ولجأوا إلى مدارسها. وقامت الكتائب التي تحتفظ بالمخطوفين بعرض التفاوض على النظام بقصد إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن عددٍ من المعتقلين لدى النظام. لكنّ النظام رفض ذلك على الرغم من ضغط أهالي المخطوفين.
كشفت مجازر العنف الطائفي أنّ درجات الضبط الاجتماعي – التي وهنت وتراجعت في سياق صيرورة تطور الأحداث في سورية - مهما امتلكت من قدرة التأثير في الحدّ من مخاطر العنف الطائفي، والذي يتعلق دائمًا بالغرائز والمشاعر العاطفية، فإنها غير كافية، وبخاصة أنّ انتشار السلاح بين الأهالي والعمليات العسكرية، تفتح المجال دائمًا للعميات الثأرية والانتقامية في مناطق التماس الطائفي.
دينامية الحراك في الساحل السوري
كان الساحل السوري من أوائل المناطق التي التحقت بالثورة السلمية بعد مدينة درعا (مدينة اللاذقية ومدينة جبلة التابعة لها ومدينة بانياس في محافظة طرطوس)[11]. وقد انقسمت النخبة العلوية في الساحل ما بين مؤيد ومعارض ووسطي في موقفها من الاحتجاجات السلمية[12]. أما الأحياء والمناطق ذات الأغلبية السنية فبقيت تشكّل القاعدة الشعبية للتظاهرات. بينما شكّلت الأحياء والمناطق ذات الأغلبية العلوية مركزًا للتأييد الشعبي للنظام في الساحل السوري. وقد أدى ذلك إلى استقطاب طائفي على خلفية مؤيد ومعارض. وفاقم هذا الاستقطاب ظاهرة "التشبيح" المنطلقة من الأحياء العلوية في البداية[13]؛ فقد كان استحضار الرجال المأجورين "الشبيحة" من جانب النظام وأجهزته في مناطق التماس في اللاذقية وبانياس وجبلة، وبحكم انتمائهم إلى الطائفة العلويّة، سلوكًا مقصودًا لدفع الفاعليات السياسية للانحراف نحو الهويات الفرعية. كما أدى خطاب السلطة في قراءة حوادث الثورة ضمن منهج المجموعات المسلحة "التكفيرية" دورًا أساسيًا في تكريس الحالة الطائفية[14]. ومن ثمّ، تأثر جزء من الشارع المحتج في ما بعد بأفكار الشيخ السلفي عدنان العرعور، والذي كان يبثّ إيحاءات وأفكار وخطابات طائفية في مضمونها. وقد انقسمت خلال هذه الفترة مدينتا بانياس وجبلة إلى سوقين تجاريين[15] بطابع مذهبي منذ الأيام الأولى للاحتجاجات[16]. وكان هذا الانقسام قد حدث قبل ذلك في حمص.
قمعت قوات الأمن السورية الاحتجاجات في مراكز المدن (اللاذقية – جبلة – بانياس) في أواخر نيسان/ أبريل 2011. وتركزت التظاهرات في أطراف مدينة اللاذقية في حي "الرمل الجنوبي" الفقير والمهمش الذي تقطنه أغلبية من مهاجري محافظة إدلب وريف اللاذقية وفلسطينيون مقيمون في سورية. لكن اقتحام الجيش السوري للحي في 14 آب/ أغسطس 2011 أنهى كل أشكال التظاهرات في الساحل السوري[17]. وعندما تبنّت المعارضة السوريّة العمل العسكري في بداية عام 2012، تركز القتال في القرى والبلدات في ريف اللاذقية حول "الحفة" و"مصيف سلمى" و"الربيعة"، وظل يحمل طابعًا ثابتًا حتى تاريخه.
ويعزى ابتعاد الساحل السوري عن أي نمط من أنماط العنف الطائفي حتى مجزرة بانياس وريف اللاذقية إلى:
- انتقال الاحتجاجات بأشكالها المختلفة تدريجيًا، تحت وقع عنف النظام، من مراكز المدن إلى الأطراف المهمّشة، ومن ثم محاصرتها هناك في مجال جغرافي ضيق لا يسمح لها بالتمدد ضمن بيئة غير مؤيدة للثورة.
- لا يوجد لدى الشارع المعارض في الساحل السوري عصبيات ذات طابع عشائري، ولا يتوافر لديها السلاح أو تُشجَّع على حمله كما في مدينة حمص. كما أنّ الأحياء المهمّشة والفقيرة في مدينة اللاذقية (الرمل الجنوبي والدعتور) المنفصلة مذهبيًا إلى حد ما، هي أحياء متباعدة.
- لم تلتحق مدن جبلة وبانياس واللاذقية بالعمل العسكري المسلح ضد النظام، ومن ثمّ، لم ينتشر السلاح فيها ولم يُستخدم من قبل الأهالي، ما منع الاحتكاكات المسلّحة بين الأطراف المتحاربة المتنافرة في مناطق التماس المذهبي؛ وهي الدينامية التي ظلت تولد العنف الطائفي والثأر بشكل متكرر في حمص وريف حماة وريف دمشق.
أسباب ظهور العنف الطائفي في الساحل السوري
لا تعود ظروف انبثاق الطائفية من ثقافة الشعب السوري وطوائفه، وإنما من الوضع الذي وجدت فيه الطوائف نفسها، ومن واقع دورها في منظومة السلطة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان الاستقطاب الطائفي جزءًا من إستراتيجية النظام لتقسيم الرأي العام وحرف الأنظار عن المنحى السياسي للصراع وتخفيف الضغط عليه، واستنفار المتطرفين الإسلاميين الذين يتذرع بهم منذ زمن طويل لتبرير سياساته القمعية. ومن ثمّ، جاءت أحداث العنف الطائفي كرد فعلٍ على هذه الإستراتيجية بأدواتها المختلفة (الشبيحة والمتطرفون الإسلاميون). وبدلًا من أن تعمل المعارضة السياسية في سورية على تفكيك هذه الإستراتيجية، انخرطت بعض أطرافها وشخصياتها في وقت لاحق في هذه العملية من خلال دفاعها عن "جبهة النصرة لأهل الشام" وتبرير أفعال بعض الأطراف في المعارضة المسلحة أو التغطية عليها.
تطوّر سير العمليات العسكرية في سورية، وصعّد كل طرفٍ استخدام الأسلحة من حيث النوع والكم، لكن الجيش السوري النظامي ظل متفوقًا باستخدام الطائرات والدبابات والبراميل المتفجرة في قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية؛ مما خلف عددًا كبيرًا من القتلى المدنيين، ومن عناصر المعارضة المسلحة أيضًا. كما ارتكبت قوات الدفاع الوطني والميلشيات العلوية المشاركة في العمليات العسكرية مجازر طائفية متعددة في ريف حماة وريف دمشق، بينما انفردت محافظة حمص بالعنف الطائفي المتبادل بصورة متكررة. وجاءت هذه الأعمال لتزيد من حدة الاحتقان الطائفي في الساحل السوري تأثرًا بمشاهد الموت اليومية وبطرق القتل البشعة، حتى أصبحت أغلب أطياف المعارضة الإسلامية المسلحة تساوي بين النظام والطائفة العلوية، وكثر الحديث في خطاباتها وبياناتها عن "النظام النصيري أو العلوي".
سلكت المعارضة أسلوب حرب العصابات، وسيطر الثوار على مناطق واسعة ونقاط عسكرية إستراتيجية، وخلّف ذلك خسائر كبيرة بين عناصر الجيش السوري. وكان قسم كبير من هذه العناصر من أبناء الساحل السوري العلويين كونهم حافظوا على ولائهم للجيش السوري تحت ضغط دعاية النظام وتخويفهم من المستقبل في حال سقوط النظام؛ مما خلق حالة من التعاطف الكبير لدى الأهالي العلويين في الساحل مع الجيش وعناصره بشكل أساسي[18].
فاقمت العوامل الخارجية المؤثرة من حدة الاحتقان الطائفي بشكل عام في أنحاء سورية كافة بما فيها الساحل، وتجلى ذلك بدخول التنظيمات الدينية كفاعل أساسي في حسم الصراع العسكري إلى جانب كل طرف من طرفي الصراع. وبدأ ذلك بهجرة مقاتلين جهاديين من تنظيم القاعدة من مختلف دول العالم إلى سورية للقتال تحت دوافع مذهبية سلفية جهادية، وتبلورت في "الدولة الإسلامية في العراق والشام"[19]، والتي يعتقد أنّ النظام استثمر فيها بوضوح، وثمة دلائل عديدة اليوم على مساهمته في دعمها. كما شاركت تنظيمات دينية شيعية في القتال إلى جانب الجيش السوري مثل حزب الله اللبناني، ومقاتلين شيعة من العراق انتظموا مع سوريين شيعة تحت اسم لواء "أبو الفضل العباس".
مخاطر العنف الطائفي في مدينة اللاذقية
على الرغم من السمة الدموية التي اتسم بها العنف الطائفي في بانياس وريف اللاذقية، فإنّ مدينة اللاذقية المختلطة طائفيًا - مركز الساحل السوري - بقيت بمنأى عن أي أحداث طائفية واضحة المعالم. كما تستضيف اللاذقية أكبر عدد من المهجّرين والنازحين من المحافظات السورية الأخرى، ويقدر عددهم بأكثر من مليون سوري، وهم لا يرغبون بدخول دوامة أخرى من العنف كونهم لجأوا إلى اللاذقية بوصفها مدينة آمنة[20]. وقد يعني ذلك عدم وجود النزعات الثأرية أو الرغبات الانتقامية في المدينة على أساس طائفي، والتي ظلت ديناميتها سائدة في توليد العنف الطائفي في حمص وريف حماة.
أدت الأسواق التجارية في اللاذقية المركزية التي تضم جميع الطوائف من أبناء المحافظة دورًا حاسمًا في تخفيف حدة الاحتقان الطائفي في مرحلة ما قبل الثورة. ولعل هذه المسألة الآخذة في التشكّل تعد من أخطر القضايا التي تهدِّد بانهيار التعايش السلمي مستقبلًا في المدينة؛ إذ يفرز الاستقطاب الطائفي صيرورة اقتصادية جديدة من خلال نمو المحلات التجارية وتوسع الأسواق في المناطق التي تقطنها أغلبية علوية، وخاصة في الرمل الشمالي ومنطقة الأزهري المتجاورتين. ويمكن فهم هذه الحالة الاقتصادية ونتائجها بمقارنتها بتأثير مشروع "حلم حمص" في عام 2005[21]، والذي تضمّن إعادة تأهيل الأحياء القديمة في مركز المدينة ذات الأغلبية السنية، إذ جُيِّر الموضوع ذو الطابع الرأسمالي باتجاه طائفي بعد أن كانت الأسواق التجارية في الأحياء العلوية قد نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة[22].
إن دخول مدينة اللاذقية في أتون العنف الطائفي سوف يؤدي بالضرورة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة؛ إذ ستؤدي تلك الأعمال إلى هجرة العائلات أيًا كانت طائفتها من الأحياء المختلطة، كما حصل في حمص. كما عاد الكثير من أفراد العائلات العلوية الساكنة في دمشق وريفها إلى الساحل السوري عدا العاملين منهم في مؤسسات الدولة. ويخشى أن يتحول الصراع من ثورة ضد الاستبداد إلى حرب أهلية واضحة المعالم، وبخاصة في ظل قيام النظام السوري - وبمساعدة لا واعية من جانب بعض أطراف المعارضة - برسم الحدود الاجتماعية في ريف حمص وريف حماة المجاورين للساحل السوري بشكل طائفي. ويخشى بعضهم أن تصل الأمور إلى تحويل فكرة الدويلة العلوية إلى واقع في حال يأس النظام من قدرته على الصمود ولجوئه للساحل. لكن هذا الطرح، وبغض النظر عن مدى واقعيته، لا يشكل محور اهتمام هذه الورقة، وقد تُخصَّص له دراسة أخرى نظرًا للأهمية التي يحظى بها في بعض المناقشات المتعلقة بمآلات الثورة السورية.
قد لا تُنتج الحروب والمنازعات الأهلية في المناطق الجغرافية المتنوعة إثنيًا وطائفيًا إلا تسويات سياسية ومحاصصة طائفية وإثنية على غرار اتفاق الطائف في لبنان. وفي حال سلكت سورية - قلب المشرق العربي - هذا المنحى في تسييس مكوناتها الاجتماعية، فسوف تضع المنطقة أمام مرحلة تاريخية جديدة مسدودة الأفق ديمقراطيًا؛ تنتقل فيها من النضال من أجل الحرية والديمقراطية إلى منازعات أهلية محلية تغذيها القوى الإقليمية والدولية لضمان أكبر قدر من المصالح الحيوية في المشرق العربي.
منذ الأيام الأولى للثورة، اختلق النظام السوري روايته التي تتحدث عن فتنة طائفية وحرب ضد السلفيين وأزمة تحركها القوى الدولية، في محاولة حثيثة لطمس الحقيقة الأساسية المتمثلة بأنها ثورة سلمية - استمرت نحو عشرة أشهر - ضد الاستبداد. وقد نجح النظام في ذلك نسبيًا في مناطق عديدة، لكنّ الثورة تبقى مستمرة بأشكال مختلفة، على الرغم من حالات القتل اليومية التي تحصد العديد من السوريين، والتي تزيد الاحتقان المجتمعي، وتولد أحيانًا العنف الطائفي في مناطق التماس المختلطة طائفيًا.
---------------------------------------------
- [1] كانت أول حادثة عنف طائفي واضحة المعالم في 16 تموز/ يوليو 2011 في مدينة حمص.
- [2] عزمي بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية، محاولة في التاريخ الراهن (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 339-340.
- [3] "مواجهة قرب بانياس واشتباك بين المسلحين والأمن التركي"، السفير، 3/5/2013.
- [4] تقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد القتلى بـ 459 قتيلًا، انظر: "أبشع جرائم العصر الحديث مجزرة بانياس نموذج صارخ عن التطهير الطائفي في سورية"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 10/5/2013، في:
http://www.syrianhr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3277
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فيقدِّر عدد القتلى بـ 145 قتيلًا، انظر: "في حصيلة جديدة بعد أسبوعين من العملية: ارتفاع قتلى "مجزرة" بانياس إلى 145"،الجزيرة نت، 16/5/2013، في:
http://www.aljazeera.net/news/pages/ffcd8865-aa8a-42e8-8bfa-b24dad1ed95b - [5] بشارة، ص 339-340.
- [6] تعود أصول علي الكيالي إلى لواء إسكندرون، ويوضح مقطع الفيديو التالي خطته للهجوم على المدينة وتنفيذه الجريمة، انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=wS_46vtIiIM - [7] هي استربة، وبومكة، وبيت الشكوحي، وبلوطة، وبارودة، وعرامو، ودرج نباتا، ودرج تلا، والحمبوشي، وجبل دورين. وهذه القرى هي المناطق المجاورة الموجودة فيها المعارضة المسلحة.
- [8] بشأن تمركز المقاتلين الليبيين في اللاذقية، انظر تقرير قناة الجزيرة: "كتيبة المهاجرين الليبية تقاتل إلى جانب الجيش الحر في اللاذقية" 19/3/2013، في:
http://www.youtube.com/watch?v=RCviGmRNSCI
ويتمركز في ريف اللاذقية عدد كبير من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم القاعدة لأسباب تتعلق بمشروعه الإسلامي، ويمكن العودة في ذلك إلى: حمزة المصطفى، "جبهة النصرة لأهل الشام من التأسيس إلى الانقسام"، سياسات عربية، العدد 5 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2013)، ص 63-75. - [9] لا توجد أرقام تقدِّر عدد الضحايا؛ إذ تستَّر الإعلام الرسمي على مقتل الأطفال والنساء وعمليات الخطف، واكتفى برصد سير العمليات العسكرية، ولم يفصح عن تلك الجريمة إلا للتغطية على مجزرة الكيماوي. لاحظ تصريحات المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان بشأن ذلك بعد مجزرة الكيماوي، فقد اتهمت المعارضة المسلحة باستخدام الكيماوي ضد الأطفال والنساء المخطوفين من اللاذقية. انظر: بثينة شعبان، "أطفال مجزرة الكيماوي خطفهم المسلحون من اللاذقية"، قناة العالم، 5/9/2013، في:
http://www.alalam.ir/news/1513686
أما المعارضة السياسية والعسكرية، فلم تر في المسألة إلا أنها عبارة عن "معركة تحرير الساحل". وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى خلال يوم الاقتحام بنحو 100 قتيل من دون أن يفصح عن طبيعة القتلى. انظر: "أكثر من 100 سقطوا خلال اشتباكات ريف اللاذقية"، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 4 آب/ أغسطس 2013، في:
http://www.syriahr.com/index.php?option=com_news&nid=8001&Itemid=2&task=displaynews#.UptFA9yno3w - [10] تقول أوساط المعارضة إنّ هذا الشيخ هو من ظهر في مقطع فيديو مع علي الكيالي خلال مجزرة بانياس، بينما تبين الصور المنشورة ومقاطع الفيديو على صفحات الإنترنت أنّ الشيخ الذي ظهر في المقطع هو موفق غزال وهو على صلة وثيقة بعلي الكيالي.
- [11] بعد خروج التظاهرات الضخمة بأعداد كبيرة إلى ساحة الشيخ ضاهر في مركز المدينة في 25 آذار/ مارس 2011، عملت بعض الشخصيات الحكومية في المدينة، والتي تحظى بدعم أو نفوذ أمني، على تجميع بعض الشباب المأجورين بالقرب من الساحة، مما أدى إلى ملاسنات طائفية بين المحتجين وهؤلاء الشباب المأجورين. وفي اليوم التالي، جابت أحياء اللاذقية ومناطقها سيارات تحذر الطوائف من بعضها وتخوف الأهالي من نية هجوم إحدى الطوائف على الأخرى. وبسبب هذه التحذيرات، تجمّع شباب كل حيّ أو منطقة لصد الهجوم المزعوم، ولكنّ وجهاء كل حي ومشايخه ابتكروا آليات ضبط اجتماعي منعت تطور الأحداث. بل وصل التنسيق في حي قنينص والأحياء المجاورة في طرف اللاذقية المتعددة الطوائف إلى الاتفاق على الخروج في تظاهرة مشتركة تعبِّر عن المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية. ولكنّ ذلك لم ينجح بسبب تطور الأحداث في مدينة اللاذقية ووقوع العديد من القتلى وتسيّد الإشاعات والخوف الموقف في المدينة. كما نزلت في هذا اليوم سيارات من قرى علوية على الطريق الدولي اللاذقية – دمشق، جاء قسم كبير منها بطلب من العائلات المرتبطة بالنظام ارتباطًا مباشرًا. وكان الهدف من ذلك خلق حالة من الفوضى والفتنة الطائفية في المدينة لتخويف الشعب السوري مما ستؤول إليه الأوضاع في سورية. لكنّ القوى العسكرية الموجودة بالقرب من دوار جامعة تشرين أجبرتها على العودة بالتنسيق مع محافظ اللاذقية في تلك الفترة رياض حجاب. من شهادة رياض حجاب، مقابلة شخصية أجراها معه باحثو المركز العربي، الدوحة، 12/3/2012.
- [12] لم تنفع مشاركة عشرات المواطنين السوريين من الطائفة العلوية ذوي الخلفية اليسارية في الاحتجاجات في تغيير هذه الصورة؛ إذ طلب المحتجون في اللاذقية منهم مغادرة اعتصام "العلبي" كي لا تقتلهم قوى الأمن وتتهم المحتجين بقتلهم، مما يؤدي إلى فتنة طائفية. كما شارك ناشطون سوريون علويون من خلفيات يسارية في التظاهرات منذ أول تظاهرة في بانياس في 18 آذار/ مارس 2011. من شهادة ناشطين من حركة "معًا" شاركوا في هذه الاعتصامات، مقابلة شخصية أجراها معهم باحثو المركز العربي، 5/7/2012.
- [13] عملت القوى الأمنية في بانياس في نيسان/ أبريل 2011 على نقل المحتجين المعتقلين إلى قرى علوية مجاورة، وقدمتهم بوصفهم سلفيين تكفيريين، وتمت إهانتهم علنًا في الشوارع. وتظهر مقاطع فيديو حالات تعذيب القوى الأمنية لمعتقلين، وفيها يتحدث المعذِّب بلهجة ساحلية مثل "بدكن حرية، هي مشان الحرية"، انظر: مقطع فيديو يوضح إهانة المعتقلين في قرية البيضا في بانياس، 12/4/2011:
http://www.youtube.com/watch?v=wGLMX-DicHY&feature=related - [14] "أكـدت أنهــا سـتتعامل بحزم لفرض الأمـن وملاحقـــة الإرهابييــن أينما وجدوا.. الداخلية: ما شهدته أكثر من محافظة مـن قتل واعتداء.. تمرد مسلح تقوم به مجموعات سلفية"، الثورة، 19/4/2011، انظر:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=44834911520110419005909 - [15] حصلت مقاطعة اقتصادية بطابع مذهبي في الأسواق التجارية الرئيسة، كما أصبح هناك سوقان للخضار إحداهما للعلويين والأخرى للسنة.
- [16] يمكن التوسّع في هذا الموضوع في: محمد جمال باروت، العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012). كانت أعمال العنف الطائفي في بانياس متوقعة الحدوث، ويمكن الرجوع في ذلك إلى: نيروز ساتيك، "الحالة الطائفية في الانتفاضة السورية: المسارات والأنماط"، في: مجموعة مؤلفين، خلفيات الثورة: دراسات سورية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 424.
- [17] "شهيدان و41 جريحًا برصاص التنظيمات الإرهابية.. قوات حفظ النظام تتعقب مسلحين في حي الرمل باللاذقية"، الثورة، 15/8/2011، انظر:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=30553445120110815020117 - [18] لا توجد حالات انشقاق عسكريين من الطائفة العلوية، لكن هناك آلاف حالات التخلف عن الالتحاق بالجيش بطرق متعددة؛ منها السفر أو التأجيل بطرق غير مشروعة، وبخاصة بعد أن قامت السلطات السورية بإعلان التجنيد الاحتياطي. ولا تتمتع قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية بتلك الشعبية التي يتمتع بها الجيش النظامي كون تلك القوات اشتهرت بعمليات السلب والنهب والقتل.
- [19] لقد سبق تشكيل جبهة النصرة مشاركة تلك الجماعات الجهادية الآتية من الخارج، مع أنّ أغلبية أعضائها من السوريين.
- [20] "اللاذقية الأولى في استقبال المهجرين تليها طرطوس والسويداء"،الاقتصادي، 18/11/2013، انظر:
http://goo.gl/51px3O - [21] هو مشروع يتضمن إعادة تأهيل المنطقة الممتدة من الساعة القديمة الشهيرة في حمص باتجاه ساحة جمال عبد الناصر والساعة الجديدة (أي مركز المدينة). وقد كان محافظ حمص السابق إياد غزال عرّاب هذا المشروع. ولذلك عندما خرجت التظاهرات في حمص كان أول مطلب لهم إقالة المحافظ.
- [22] بشارة، ص 69.
كتب
عُرِف عزمي بشارة بإنتاجه الفكري الغزير وأبحاثه المرجعية في مجالات المجتمع المدني، ونظريات القومية وما أسماه "المسألة العربية"، والدّين والعلمانية